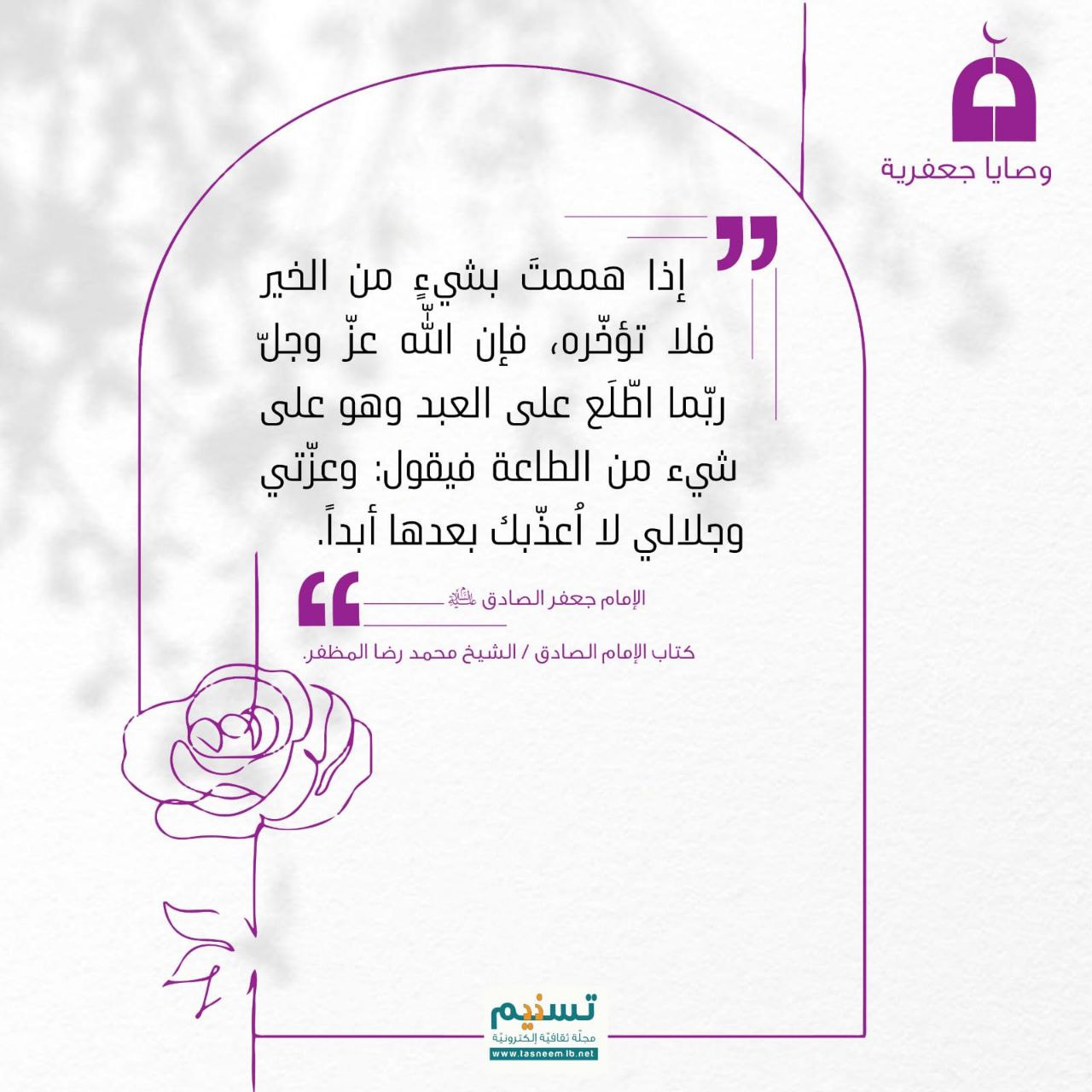أخلاق
أخلاق- ها هو اليـتـيم بعين الله |20| والأغرب

ثقافتنا
ها هو اليـتـيم بعين الله
|20|
والأغرب من ذلك، عشية ذلك اليوم، إذ بتنا في بعض الطريق، وقد ساورتنا هواجس.
انطلقت فـي عـجـب وحـيـرة لأخـبـر الـحـارث، فــإذا هـو يسبقني بالهتاف: حليمة، معجزة.. معجزة، ضرع الناقة ممتلئ.. حافل! لـم أكـد أصـدقـه؛ فحمل إلـي قـدحـا طـافـحـا مـن اللبن العاجي اللون، شربته فصدقته وآمنت بما ادعى.
سبق أن أخبرت حليمة أنني ضقت ذرعـا بفراق حفيدي، وكذلك كان شأن آمنة، فهي التي تصدعت بعد موت عبد الله كمدًا وحزنا، ولم ينقطع لها نحيب.
ولـمـا تـنـاهـى الـخـبـر إلـى مـسـامـع الـمـرضـعـة، عـاهـدت نفسها - لفترة ما - أن تحمل محمدًا إلى مكة، كل شهر مرة»
دفـعـت الرضيع إلـى حليمة غير كـارهـة؛ فقبيلة سعد عرفت بين العرب بالشجاعة والفصاحة وجمال اللغة وسلامة النطق وبلاغة البادية على جفافه وحر نهاره أصح وأنقى بـمـا أن مـكـة أرض مـنـبـطـحـة، شـكـت وبــاء وتـلـوثـًا على الصغار والرضعاء، ثم إن النشأة في رحاب البادية أصلح لنمو الأطفال، لكن أين كل ذلك من حديث شوقي وحنيني.
كان مولاي عبد المطلب يتودد إلى حليمة وبعلها كثيرًا إذ جـاءت حليمة لتأخذ مـحـمـدا، سألها مــولاي: يـا ابنتي، ما اسمك، ومن هو بعلك؟
أجابت: أنا حليمة السعدية ابنة أبي ذؤيـب، وزوجـي الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي
"طالما أرضعت من أبناء الشرفاء بمكة، وكم كنت أمنح الصغار المودة، إلا أن لهذا الرضيع عندي موقعًا خاصًا؛ فمنذ التقت مناه، النظرات، وابتسم في وجهي، دامني من حيث لا أشعر حبّه وتعلّق به قلبي.
ولما لمست البركة ونالني منه اليمن، زدت شغفًا إلى شغفي كــان حـنـوي عـلـيـه حـنـوا عظيما مما سـاورنـي الـقـلـق على ضمرة، وخفت أن أتغافل عن رعايته وأقصر في الحنان عليه.
ما كلفت به أنـا فحسب، بل شغف به زوجـي الـحـارث، وكثيرًا من النسوة في القبيلة حتى صغارهن -ابنتي خذامة أو الشيماء- كما غلب ذلك على اسمها فقد كانت آنئذ في ربيعها الثامن، هامت به وعشقته، وصارت خير عون لي في الحدب عليه والقيام بشؤونه.
لم أتكلف عناء، ولم أتلق مشقة في تربيته، كما تلقيتها في تـربـيـة أولادي. شـب شـبـابًا لم يشبه بقية الغلمان.
كان دوما على طهر ونـقـاء، فلما اشتد عـوده، لم يصبح على رمص وغمص كما كان كثير من الصبيان يصبحون.
لم أنس ما قالته لي يومًا الشيماء: كان أخي القرشي يقوم من نومه مغسول الوجه، صقيلا! كـان الأطـفـال يتخالسون الفطور إلا مـحـمـدًا، فلم يكن ليبسط يده إلى طعام أحدهم أبدًا.
كنت أحرسه اذ انطلق إلى البادية، كان دومًا يلوذ بالصمت ويزهد في الكلمات.
يـلـعـب مـعـنـا، ثـم يـتـحـول إلــى زاويــة مـعـتـزلا. فـيـمـد الـبـصـر إلـى مكان البعيد، إلـى الـسـمـاء. ولـمـا كنا نبيت خـارج الـمـضـارب بـالـحـي يـطـيـل الـنـظـر إلــى الـسـمـاء.
وفي الصحراء، ذهب ذات مرة ليتسلق الجبل وحده، دون أن يحيط الآخـريـن بـه عـلـمًا، فظن أنه ضاع، فأقبل على الحي، مسرعًا ليقص عليهم ما جرى وحدث.
انطلقت أمي نحو المرتع من فورها، فرأته جالسًا على شاهق، وقـد حـدق في السماء. أقبلت عليه وضمته إلـى صـدرهـا، وقبلت بين حاجبيه، فعادت به إلى المضارب دون أن توبخه أو تؤنبه.
لم يكن يطيبني أن نرد محمدًا إلى أمه. فطالما تداولنا الحديث - أنـا وحليمة - عـمـا أفــاض علينا محمد مـن الـيـمـن والـبـركـة؛ فمنذ، قدومه، أخصب عيشنا، فرقّ وطاب وازدادت الإبل، ودرّت الأنعام. وشعشعت علينا شمس السعادة والهناء. لـكـن مـا بـالـيـد حـيـلـة؛ فـلـيـس كـل مـا يـتـمـنـى الـمـرء يــدركــه، ولا الفلك يدور بما يتمناه!
يتبع..